كيف
أصبح الأدب مهدداً
تزفيتان
تودوروف
ترجمة
محمد العرجوني
مراجعة
محمد الغرايب
تصميم الغلاف نصر سامي
تقديم: تزفيتان تودوروف
كلما عادت بي الذكريات إلى الماضي البعيد،
إلاّ ووجدتني محاطاً بالكتب، لأن والدَيّ كانا
يمتهنان الوراقة، وكانت الكتب تملأ علينا البيت. وكان والدي وأمي
منهمكين باستمرار
في تدبير أمر رفوف جديدة لتدكين هذه الأعداد الهائلة من الكتب. وفي انتظار إيجاد
ذلك، كانت الكتب تتراكم في الغرف والممرات، مشكلة طغوات آيلة للسقوط. وإذا ما
أردتُ المرور أجدني مضطراً إلى الزحف وسطها. وهكذا تعلمت القراءة بسرعة، وبدأت
أقرأ بنهم شديد القصص الكلاسيكية الموجهة للشباب والمنشورة بتصرف، كألف ليلة وليلة
وحكايات كريم وأندرسين وطوم سويير، وأوليفر تويست والبؤساء. وفي يوم من الأيام،
وكنت في الثامنة من عمري أنذاك، قرأت رواية بكاملها، فشعرت بالزهو والافتخار، حتى
أني دونت ذلك في يوميتي الشخصية بهذه العبارة: «لقد قرأت اليوم، وأنا جالس على
ركبتي جدي، كتابا مكونا من 223 صفحة، خلال ساعة ونصف!»
كنت دوماً شغوفاً
بالمطالعة وأنا تلميذ بالإعدادي وبالثانوي. وكان الغوص في عالم الكتاب يثير في
داخلي دائماً قشعريرة من النشوة، ولم أكن أفرق بين نتاج الكلاسيكيين أو المعاصرين،
سواء كانوا بلغاراً أو أجانب من الذين كنت مدمناً على قراءة نصوصهم الكاملة، وكنت
ألبي فضولي وأعيش المغامرات و أتذوق الشعور بالخوف والسعادة دون أن أعيش القمع
الذي كان ينتظرني في علاقاتي بأترابي من الأولاد والبنات الذين عشت معهم. وكنت عما
أريد أن أكون عَمٍ، لكن كنت متأكداً أن مستقبلي سيكون مرتبطاً بالأدب. فهل علي أن
أساهم في الكتابة؟ لقد جربت ذلك، وكتبت قصائد تافهة جداً، ومسرحية من ثلاثة فصول،
خصصتها لحياة الأقزام والعمالقة، وشرعت في تدبيج إحدى الروايات، لكن ما أن انتهيت
من الصفحة الأولى حتى أحسست أنها ليست سبيلي، وعلى الرغم من أني كنت دوماً في ريب
من آتي الأيام، فإني اخترت في متم دراستي الثانوية شعبتي في الجامعة، وقررت متابعة
دروسي في الآداب، وهكذا التحقت بجامعة صوفيا سنة 1956؛ فبدا واضحاً أن مهنتي ستكون
هي الحديث عن الكتب.
كانت بلغاريا آنذاك
جزءاً من المعسكر الشيوعي، وكانت دراسة الآداب فيها خاضعة للإيديولوجيا الرسمية،
ودروسها موزعة نصفين، نصفها الأول معرفي بحت، ونصفها الثاني دعائي، وهكذا
أضحت قيمة المؤلفات القديمة أو المعاصرة،
تقاس بمدى ملاءمتها للعقيدة الماركسية اللينينية. وكان الشغل الشاغل للشيوعيين هو
تبيان مدى تمثيل تلك المؤلفات للإيديولوجية الرسمية. وبما أنني لم أكن أقتسم ذلك
الإيمان الشيوعي، ولم يكن هناك ما يسخطني، كنت، كأمثالي الكثيرين، أتصرف بشكل
مختلف، إذ كنا أمام العموم، نجيز في صمت أو على مضض الشعارات الرسمية، لكن عندما
نعود إلى حياتنا الخاصة، كنا نكثف اللقاءات ونكثر القراءات التي تهم على الخصوص
أولئك الكتاب الذين لم يكونوا في نظرنا شيوعيين، لان الحظ كان قد أسعفهم، وعاشوا
قبل ظهور الماركسية اللينينية، أو كانوا يعيشون في دول سمحت لهم بكتابة ما رغبوا
فيه بكامل الحرية.
كان النجاح في الدراسات
العليا مشروطاً، في نهاية السنة الخامسة، بتحرير عرض لنيل شهادة التبريز. فما
السبيل إلى كتابة موضوع أدبي دون خضوع للإيديولوجية الحاكمة؟ لقد سلكت طريقاً
نادراً تفادياً للتجنيد العام، طريق يحتفي بالمواضيع دون العودة إلى الإيديولوجية،
ويسمح بالاهتمام في المؤلفات الأدبية بمادية النص، وبأشكاله الألسنية. وللإشارة،
لم أكن وحدي من دخلت غمار هذه التجربة: فمنذ عشرينيات القرن العشرين، كان
الشكلانيون الروس قد دشنوا هذا النهج، واقتفى أثرهم بعد ذلك آخرون. وكان الأستاذ
المختص في التفعيلة هو أهم أستاذ لدينا في الجامعة أنذاك. هكذا آثرت تقديم عرض
يهتم بمقارنة نسختين لأقصوصة طويلة لكاتب بلغاري، كُتبت بداية القرن العشرين، واقتصرت
فيه على التحليل النحوي وعلى ما طرأ من
متغيرات ألحقها بنص النسخة الثانية، حلت فيه الأفعال المتعدية محل الأفعال
اللازمة، وأصبح الفعل التام (perfectif) أكثر حضوراً من غير التام... وهكذا لم يكن للرقابة من سبيل على
ملاحظاتي! ولم أكن أخاطر بعملي هذا بتحدي طابوهات الحزب الإيديولوجية.
لا أستطيع التكهن
بنهاية هذه اللعبة التي تشبه لعبة القط والفأر – بالتأكيد لم يكن الأمر في صالحي.
وجاءتني فرصة للذهاب إالى "أروبا" لمدة سنة، كما كنا نقول آنذاك.
بمعنى الذهاب إلى ما وراء "الستار الحديدي" [صورة لم نكن نطلقها
جزافاً لأنه كان من المستحيل المرور عبر هذه الحدود]. اخترت باريس -مدينة الفنون
والآداب- التي كانت سمعتها تبهرني، وهي المكان الذي لن يعرف له حبي للآداب أية
حدود، مكان يسمح لي بالجمع، بكل حرية، بين قناعاتي الشخصية، وانشغالاتي العمومية،
وتحرّرت بهذا الشكل من الانفصام الجماعي المفروض من طرف النظام الشمولي البلغاري.
لكن
تبين
لي أن الأمور هي أصعب مما كنت أتصوّر. فقد تعوّدت، أثناء دراساتي الجامعية، أن
أستدل بعناصر المؤلفات الأدبية التي لم تكن خاضعة للإيديولوجية من مثل الأسلوب
والنحت وأشكال السرد، أي بالتقنية الأدبية. وكنت مقتنعاً في بداية الأمر بأن مكوثي
في فرنسا لن يدوم أكثر من سنة، أي مدة صلاحية الجواز المسلم لي. وكان غرضي إذن هو
استغلال هذه المدّة ما أمكن لتعلم كل ما له صلة بهذه المواضيع، التي لم تكن تولى
أية أهمية في بلغاريا، ولا يعبأ بها وتهمش، لأنها لا تخدم قضية الشيوعية، وكان من
المفروض أن تدرس بعمق في بلد تعم فيه الحرية! لكن وجدت صعوبة في الاستدلال بهذا
النوع من الدراسات، في كليات باريس، إذ كانت دروس الأدب فيها موزعة حسب القوميات
والقرون، ولم أهتد إلى أي أستاذ من المهتمين بهذا الشأن لآخذ عنه ما كنت أبحث عنه.
ووجب القول إنه لم يكن من السهل الإلمام بمتاهات الأنظمة المدرسية وبرامجها، خاصة
بالنسبة لطالب أجنبي مثلي.
كنت مدعوماً برسالة من
قيدوم كلية الآداب بصوفيا، حملتها إلى زميله بباريس. وفي يوم من أيام شهر مايو من
سنة 1963، قرعت باب مكتب بالسوربون [الجامعة الباريسية الوحيدة آنذاك]، والذي لم
يكن سوى مكتب قيدوم كلية الآداب، المؤرخ أندري أيمار (André
Aymard)؛ ولما اطلع على
رسالة زميله بصوفيا، سألني عن حاجتي، فأجبته برغبتي في متابعة دراساتي حول الأسلوب
واللغة ونظرية الأدب – بصفة عامة. فأجابني بقوله: «لا يمكن أن تدرس هذه المواد
بصفة عامة! في أي أدب تريد التخصص؟» - أحسست آنذاك بأن الأرض انزاحت من تحت
قدمي، وقلت بكلام غير مفهوم وبشكل يثير الشفقة: «إن الأدب الفرنسي يهمني».
لاحظت في الوقت نفسه أنني كنت أغرق في فرنسيتي، التي لم تكن سليمة آنذاك. نظر إليّ
متنازلاً واقترح علي دراسة الأدب البلغاري، تحت إشراف أحد المختصين فيه الموجودين
بفرنسا.
أحسست بنوع من الإحباط
من جراء هذا اللقاء. ومع ذلك، تابعت بحثي مستعيناً ببعض معارفي، وفي يوم من
الأيام، قال لي احد أساتذة علم النفس، بعد أن استمع إلى ما تعرضت له من صعوبات،
وكان زميلاً لصديق لي: «أعرف شخصاً آخر يهتم بهذه الأمور الغريبة ويحاضر
بالسوربون، اسمه جرار جنيت (Gerard
Genette)». التقينا في ممر مظلم بزنقة سربنت (Serpente)، حيث كانت توجد بعض
الأقسام الخاصة بالدروس؛ وحينها تبادلنا أطراف الحديث بكثير الدفء. وأخبرني فيما
اخبر به بوجود أستاذ كان يسير ندوة بمدرسة الدراسات العليا، واقترح علي لقاءه،
وكان اسم هذا الأستاذ هو رولان بارث (Roland
Barthes)، إلا أنني لم أكن قد
سمعت به من قبل.
ارتبطت بدايات حياتي
المهنية بهذه اللقاءات. وقررت بسرعة أن مدة سنة واحدة بفرنسا غير كافية، وأنه كان
لزاماً علي المكوث لمدّة أطول بهذا البلد. سجلت نفسي عند بارث ليشرف على أول
دكتوراة لي، وهو ما حصل فعلاً، حيث ناقشتها سنة 1966. بعدها بقليل، التحقت بالمركز
الوطني للبحث العلمي، حيث قضيت حياتي المهنية. خلال تلك الفترة أيضاً، وبتشجيع من
جنيت، ترجمت إلى اللغة نصوص الشكلانيين الروس إلى الفرنسية، ولم يكن هؤلاء
الشكلانيون معروفين جيداً بفرنسا، وجمعتها في كتاب عنونته بـ: نظرية الأدب،
صدر سنة 1965. وفيما بعد، ودائماً بمعية جنيت، قمنا بتنشيط مجلة بويتيك (Poétique)، لمدة عشر سنوات، إذ
كانت مدعمة كذلك بمجموعة خاصة بالبحوث، وحاولنا استمالة تدريس الأدب بالجامعة
لتحريره من ربقة القوميات والقرون، وتمكينه من الانفتاح على ما يمكن أن يقرب
المؤلفات فيما بينها.
أمّا السنوات التي تلت
تلك المرحلة، كانت تعد بمثابة فترة الاندماج التدريجي بالنسبة لي داخل المجتمع
الفرنسي. تزوجت. وأنجبت، وأصبحت كذلك مواطناً فرنسياً. بدأت أنتخب وأقرأ الجريدة،
وأهتم أكثر بالحياة العامة، مقارنة مع اهتمامي بها في بلغاريا. لأنني اكتشفت أن
هذه الحياة ليست بالضرورة خاضعة للمعتقدات الإيديولوجية، كما هو الشأن بالنسبة
للبلدان الشمولية. وبدون السقوط في الإعجاب المفرط، أحسست بالسعادة وأنا ألاحظ أن
فرنسا كانت بلداً ديمقراطياً يؤمن بالتعدد. بلد يحترم الحريات الفردية. هذه
الملاحظة كانت هي الأخرى تؤثر في اختياري حينما كنت أهم بمقاربة النصوص الأدبية:
إن الفكر والقيم الذين يتشكل منهما كل مؤلف، لم يكونا حبيسي الغل الإيديولوجي
المسبق، لهذا لم يكن هناك أي داع لتهميشهم أو إهمالهم. أسباب اهتمامي الخاص
بالمادة الفعلية (verbale) للنصوص، لم تعد سارية المفعول. منذ ذلك الوقت، في أواسط
السبعينات، فقدت شهيتي اتجاه مناهج التحليل الأدبي، وتشبثت بالتحليل نفسه، أي
باللقاء بالكتاب.
بناء على ذلك، لم يعد
حبي للأدب محدداً بالتربية التي تلقيتها في بلادي الشمولية. ومباشرة، كان علي
البحث لامتلاك وسائل جديدة للعمل؛ أحسست بالحاجة إلى الاستئناس بمعطيات ومفاهيم
علم النفس، والأنتروبولوجية والتاريخ. وبما أن أفكار الكتاب أصبحت تجد قوتها
الكاملة، أردت أن أغوص في تاريخ الفكر الخاص بالإنسان، ومجتمعاته وفي الفلسفة
الأخلاقية والسياسة، لفهمها أحسن.
لذلك، فإن موضوع هذا
العمل نفسه، الخاص بالمعرفة، قد اتسع. إن الأدب لا يولد من فراغ، لكن داخل مجموعة
خطابات حيّة، يقتسم معها عدّة خصائص؛ وليس صدفة، إذا كانت حدوده متغيرة عبر
التاريخ. أحسست أن تلك الأشكال الأخرى للتعبير تجذبني، ليس على حساب الأدب، لكن
بالقرب منه. قرأت في كتاب فتح أمريكا حكايات الرحل والفاتحين الإسبان للقرن السادس
عشر، وقرأت كذلك لمعاصريهم من الأزتيك والمايا، لمعرفة كيف يتم اللقاء بين ثقافات
مختلفة جداً. وللتفكير في حياتنا الأخلاقية، غصت في كتابات المعتقلين القدماء داخل
المعتقلات الروسية والألمانية؛ وهو ما دفعني الى كتابة: في مواجهة الأقصى. رسائل
بعض الكتاب، سمحت لي بالتساؤل حول مشروع وجودي: يتجلى في كون الإنسان [الكاتب]
يجعل حياته في خدمة الجمال، وذلك في كتابي: مغامرو المطلق. النصوص التي كنت
أقرأها، من مثل الحكايات الشخصية و المذكرات والمؤلفات التاريخية، والشهادات
والطروحات والرسائل والنصوص الفلكلورية المجهولة، كلها لا تتقاسم مع المؤلفات
الأدبية حالة الخيال الأدبي، لأنها تتصف بالمباشرة في وصف الأحداث المعيشة، ومع
ذلك، فمثلها مثل النصوص الأدبية، تسمح لي باكتشاف أبعاد مجهولة للعالم، تؤثر في
وتحثني على التفكير. بعبارات أخرى، فإن مساحة الأدب قد اتسعت بالنسبة لي بما أنها
أصبحت، إلى جانب الأشعار
والروايات والأقصوصات والمؤلفات الدرامية، تشمل المساحة الواسعة للكتابة السردية
الموجهة إلى العموم أو الخاصة و كذا الأطروحات والعروض.
وإذا
تساءلت اليوم لماذا أحب الأدب، فسأجيب بطريقة عفوية: لأنه يساعدني على الحياة. لن
أطلب منه أكثر، كما في سن المراهقة، كي يساعدني على تفادي الجراح التي من الممكن
أن أكون ضحيتها أثناء لقاءات مع أشخاص واقعيين؛ وعوض أن أقصي التجارب المعيشة،
فإنه يجعلني أكتشف عوالم توجد باستمرار معها، ويسمح لي بفهمها أحسن. لا أظن أنني
الوحيد من ينظر هكذا للأدب. إنه أكثر كثافة. وأكثر طلاقة من الحياة اليومية، لكنه
ليس جذرياً مختلفاً عنها. فالأدب يوسع كوننا، ويحثنا على تخيل طرق أخرى لتصوره
وتنظيمه. كلنا مكونين مما أعطتنا المخلوقات الإنسانية الأخرى: آباؤنا في البداية،
ثم من هم حولنا؛ إن الأدب يفتح إلى ما لا نهاية إمكانية التفاعل مع الآخر. هكذا
يساهم في إغنائنا إلى ما لا نهاية، يجعلنا نشعر بأحاسيس من غير الممكن تعويضها،
أحاسيس تجعل العالم الواقعي مليئا بالمعاني وأكثر جمالاً. وبعيداً عن كونه مجرد
زينة، وملهاة خاصة بالمثقفين، فإنه يسمح لكل واحد بتحقيق نزوعه إلى أن يكون إنساناً.
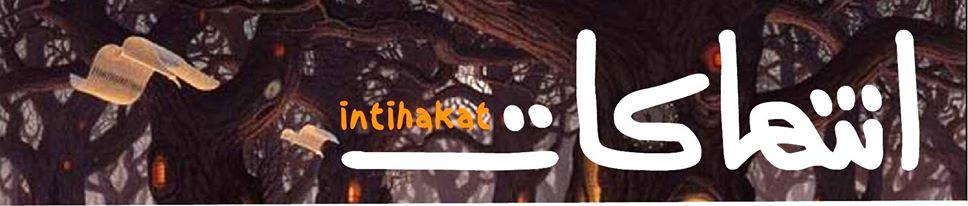

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق